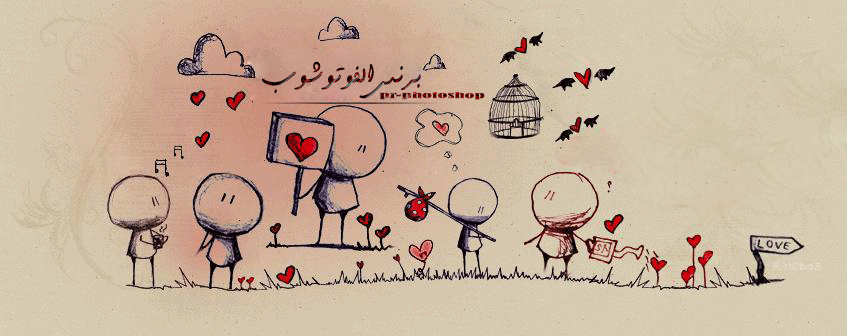هذه قصه لبر الوالدين
الآن.. الآن.. وليس غدا
هذه قصه من بريد الاهرام يرويها مرسلها فاقرأوها للنهايه وهى أبلغ من أن يكون
عليها أى تعليق الا لاحول ولاقوه الا بالله!!؟؟
جاءني يبكي بحرارة شديدة ودموع الحزن والألم تنساب من عينيه, ثم تماسك للحظات
ليخبرني أن والدته غادرت عالمنا إلي دار الحق, فهدأت من روعه, وذكرته بأن
الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الدنيا هي الموت, وأنه حق علينا جميعا,
فقال أنا لا أبكي لوفاتها برغم لوعة الفراق, ولكني أكاد أموت كمدا لأني لم
أكن بارا بها, كما يجب وأحيانا كنت أقصر في حقها وأشعر بأنها كانت سندي
الوحيد في هذه الدنيا, وأن الدنيا بعد غيابها أدارت لي ظهرها, واستمر يحكي
أنها منذ نحو عشر سنوات ـ وكانت حينئذ في الستين من عمرها ـ أصيبت بمرض عضال
حرمها من أن تحيا حياة طبيعية, وبرغم ذلك فإن ابتسامة الرضا بقضاء الله وقدره
لم تفارق أبدا وجهها, وكان يتردد عليها من آن لآخر, وكثيرا ما شغلته هموم
العمل والدنيا عن السؤال عنها, فكان يغيب عنها, أسابيع طويلة برغم أنه
الوحيد الذي بقي لها في الدنيا بعد رحيل الزوج والأهل والأحباب, ووضع يديه
علي عينيه متحسرا, وقال إنه أودعها بيديه هاتين في إحدي دور المسنين فلم ترفض
أو تعترض, ولم تغب أبدا ابتسامتها, بل إنها كانت تطمئن عليه من كل زوار
زملائها في الدار دون أن تثقل عليه يوما بطلب زيارتها أو السؤال عنها!! ونسي
مع مرور الوقت أن يدفع مصروفات إقامتها في دار المسنين فغادرتها إلي بيتها دون
أن ترسل له أو تسأله أن يدفعها, ربما اعتقادا منها أنه عجز عن سدادها لضيق
ذات اليد.
وذات ليلة دق جرس التليفون في مكتبه في الإسكندرية ليجد علي الطرف الآخر أحد
جيران والدته يبلغه أن والدته قلقة عليه, وتريد فقط أن تطمئن أنه بخير وفي
أحسن حال, وأحس بقلبه ينقبض, وشعر بأن والدته في خطر فترك مكتبه عائدا في
سرعة الريح إلي القاهرة, وتوجه علي الفور إلي حيث تقيم في أحد أحياء مصر
القديمة, ودق جرس الباب فلم يرد أحد, ولكنه سمع أنينا خافتا ينبعث من
الداخل فقفز من السور الخلفي للمنزل, ودخل إلي حجرة والدته ليجدها منكفئة علي
وجهها ودموعها تبلل كتاب الله الذي سقط من يدها, ووقف أمامها جامدا للحظات من
هول المفاجأة, وأفاق بسرعة من غيبوبته ليمد يده إلي رأسها يرفعها ليري وجهها
فوجد نفس ابتسامة الرضا التي تعود أن يراها, وما إن رأته حتي شهقت بصعوبة
بالغة, وقالت: ولدي, ثم فارقت الحياة فانهار ساجدا إلي جوارها يقبل يديها
ورجليها طالبا الصفح والمغفرة.
ربت علي كتف صديقي مواسيا له في محنته وساد بيننا صمت كسواد الليل, قطعه صوت
المؤذن يرفع آذان صلاة العشاء فدعوته للصلاة والدعاء لوالدته بالرحمة
والمغفرة, وانتهينا من الصلاة ورأيته يسجد طويلا وهو يبكي بحرقة ويهذي بكلمات
تمزق نياط القلوب, وتركته ساجدا يغسل بدموعه آثار ماض يعذبه, بسبب تقصيره
في حق والدته التي كانت ـ كما يقول ـ مثالا للحنان والحب والعطاء بلا حدود وبلا
انتظار لأي مقابل حتي ولو كان كلمة شكر أو عرفان.
فيا أيها الأبناء عودوا إلي آبائكم وأمهاتكم الآن فقبلوا أيديهم وأرجلهم ودعوهم
يضمونكم إلي أحضانهم فهذا هو زادهم وأقصي آمالهم وأحلامهم, وهم في ربيع
العمر.
وافعلوا ذلك الآن, وليس غدا قبل ن تضيع الفرصة, ويأتي يوم لا ينفع فيه
الندم!!.
الآن.. الآن.. وليس غدا
هذه قصه من بريد الاهرام يرويها مرسلها فاقرأوها للنهايه وهى أبلغ من أن يكون
عليها أى تعليق الا لاحول ولاقوه الا بالله!!؟؟
جاءني يبكي بحرارة شديدة ودموع الحزن والألم تنساب من عينيه, ثم تماسك للحظات
ليخبرني أن والدته غادرت عالمنا إلي دار الحق, فهدأت من روعه, وذكرته بأن
الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الدنيا هي الموت, وأنه حق علينا جميعا,
فقال أنا لا أبكي لوفاتها برغم لوعة الفراق, ولكني أكاد أموت كمدا لأني لم
أكن بارا بها, كما يجب وأحيانا كنت أقصر في حقها وأشعر بأنها كانت سندي
الوحيد في هذه الدنيا, وأن الدنيا بعد غيابها أدارت لي ظهرها, واستمر يحكي
أنها منذ نحو عشر سنوات ـ وكانت حينئذ في الستين من عمرها ـ أصيبت بمرض عضال
حرمها من أن تحيا حياة طبيعية, وبرغم ذلك فإن ابتسامة الرضا بقضاء الله وقدره
لم تفارق أبدا وجهها, وكان يتردد عليها من آن لآخر, وكثيرا ما شغلته هموم
العمل والدنيا عن السؤال عنها, فكان يغيب عنها, أسابيع طويلة برغم أنه
الوحيد الذي بقي لها في الدنيا بعد رحيل الزوج والأهل والأحباب, ووضع يديه
علي عينيه متحسرا, وقال إنه أودعها بيديه هاتين في إحدي دور المسنين فلم ترفض
أو تعترض, ولم تغب أبدا ابتسامتها, بل إنها كانت تطمئن عليه من كل زوار
زملائها في الدار دون أن تثقل عليه يوما بطلب زيارتها أو السؤال عنها!! ونسي
مع مرور الوقت أن يدفع مصروفات إقامتها في دار المسنين فغادرتها إلي بيتها دون
أن ترسل له أو تسأله أن يدفعها, ربما اعتقادا منها أنه عجز عن سدادها لضيق
ذات اليد.
وذات ليلة دق جرس التليفون في مكتبه في الإسكندرية ليجد علي الطرف الآخر أحد
جيران والدته يبلغه أن والدته قلقة عليه, وتريد فقط أن تطمئن أنه بخير وفي
أحسن حال, وأحس بقلبه ينقبض, وشعر بأن والدته في خطر فترك مكتبه عائدا في
سرعة الريح إلي القاهرة, وتوجه علي الفور إلي حيث تقيم في أحد أحياء مصر
القديمة, ودق جرس الباب فلم يرد أحد, ولكنه سمع أنينا خافتا ينبعث من
الداخل فقفز من السور الخلفي للمنزل, ودخل إلي حجرة والدته ليجدها منكفئة علي
وجهها ودموعها تبلل كتاب الله الذي سقط من يدها, ووقف أمامها جامدا للحظات من
هول المفاجأة, وأفاق بسرعة من غيبوبته ليمد يده إلي رأسها يرفعها ليري وجهها
فوجد نفس ابتسامة الرضا التي تعود أن يراها, وما إن رأته حتي شهقت بصعوبة
بالغة, وقالت: ولدي, ثم فارقت الحياة فانهار ساجدا إلي جوارها يقبل يديها
ورجليها طالبا الصفح والمغفرة.
ربت علي كتف صديقي مواسيا له في محنته وساد بيننا صمت كسواد الليل, قطعه صوت
المؤذن يرفع آذان صلاة العشاء فدعوته للصلاة والدعاء لوالدته بالرحمة
والمغفرة, وانتهينا من الصلاة ورأيته يسجد طويلا وهو يبكي بحرقة ويهذي بكلمات
تمزق نياط القلوب, وتركته ساجدا يغسل بدموعه آثار ماض يعذبه, بسبب تقصيره
في حق والدته التي كانت ـ كما يقول ـ مثالا للحنان والحب والعطاء بلا حدود وبلا
انتظار لأي مقابل حتي ولو كان كلمة شكر أو عرفان.
فيا أيها الأبناء عودوا إلي آبائكم وأمهاتكم الآن فقبلوا أيديهم وأرجلهم ودعوهم
يضمونكم إلي أحضانهم فهذا هو زادهم وأقصي آمالهم وأحلامهم, وهم في ربيع
العمر.
وافعلوا ذلك الآن, وليس غدا قبل ن تضيع الفرصة, ويأتي يوم لا ينفع فيه
الندم!!.